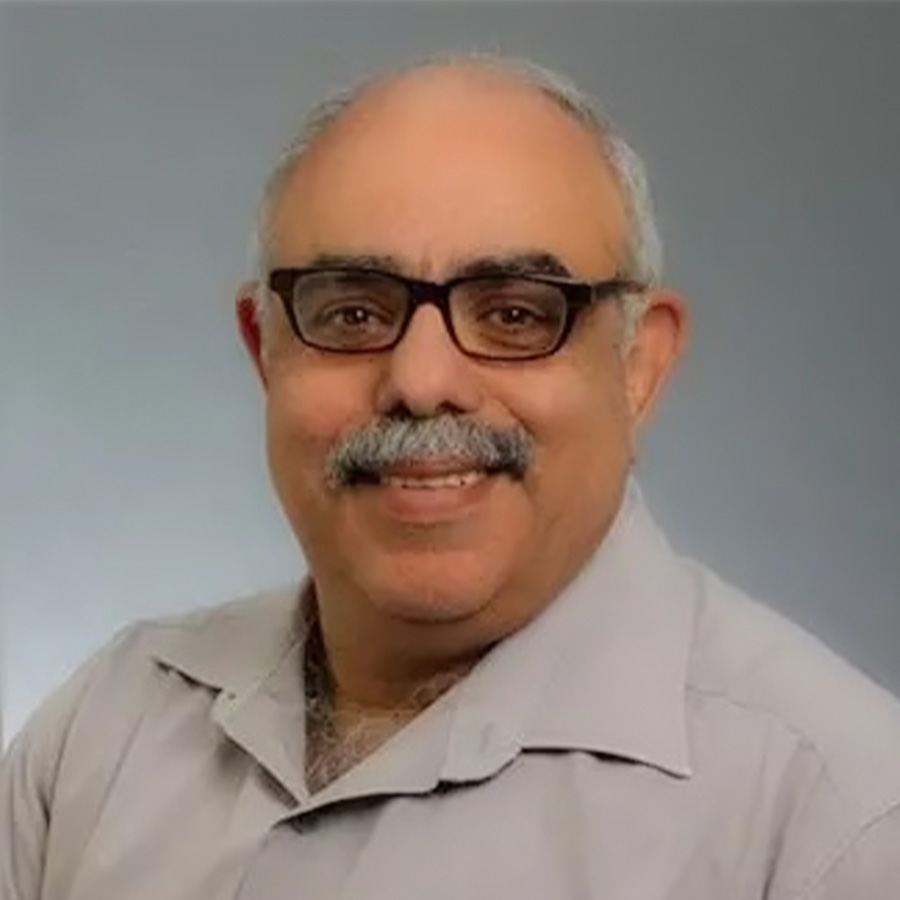
مازن عرفة
روائي وباحث من سوريا
من الأسطورة إلى المُحاكاة: رحلة الوعي الإنساني في مواجهة المجهول

منذ بدايات القرن الحادي والعشرين، يتسارع الزمن في حياتنا بطريقة مذهلة لا نستطيع التقاطها، ومثله تغير أنماط الحياة الاجتماعية والإنسانية، والاكتشافات المتلاحقة في العلوم والتقنيات، فيما تغدو حيواتنا أكثر فأكثر لحظات عابرة في مسيرة «الوجود»، لا ندرك فيها لا البدايات ولا النهايات، بل والوجود نفسه يبدو كل يوم أكثر إلغازاً وإبهاماً، على الرغم من كل التقدم المعرفي الذي وصلته الإنسانية.
يمرّ نهارنا سريعاً في زحمة «الوسائط الاجتماعية الإلكترونية»، بعوالمها الرقمية، في كثافة استنزاف أرواحنا بـ «ثقافة الاستهلاك المادية واللامادية»، وحصارات «العولمة» و«ما بعد العولمة» لحياتنا اليومية، بتوحشاتهما اللا إنسانية. نصبح في هذه الأجواء الهلامية مفتقدين لهويتنا الوطنية بانكسار أشكال الحدود الجغرافية ـ السياسية والاقتصادية والثقافية، وقريباً هويتنا الإنسانية باندماجنا جميعاً في «القطيع الإلكتروني العالمي».
نتلقى، عبر وسائط التواصل الاجتماعية، أخبار المجازر اليومية الكارثية، الهائلة الحجم والاتساع، على مستوى العالم بأجمعه، مجرد أرقام إحصائية، نمر عليها دون أن تعنينا المآسي الكامنة فيها. تختلط هذه الأرقام بالإعلانات عن المنتجات الاستهلاكية التي تغمرنا كضرورات أساسية للحياة. نفتقد الوعي بما يحدث حولنا، أو بالأحرى يصبح وعينا مقولباً، ليتقبل كل ما حولنا «لا حدثاً انفعالياً»، بل صورة عابرة.
نستيقظ ذات صباح (أي صباح؟)، فإذا بنا نحن فجأة في صباح ثانٍ، دون إدراك مرور الزمن. بل أصبحنا نعيش في صباح واحد، أو بالأحرى نعيش بلا صباحات. تتجاوز حياتنا مفاهيم الزمن الكلاسيكي المطلق مع «نيوتن»، ونغرق في «زمكان نسبية أينشتاين»، حيث يختفي الماضي والحاضر والمستقل. بل نحن نغادر الزمكان إلى هلامية لا يقينية مع «الفيزياء الكوانتية»، حيث «الحدث» هو «أحد احتمالات وجود لا نهائية». تسارع الحياة المجنونة، التي نعيشها الآن في هذه الأجواء يجعل حياتنا ومضة في وجود غير مدرك.
منذ بداية القرن الحادي العشرين، ورؤانا للوجود تتبدل باستمرار، بتسارع شديد:
نتجاوز مفاهيم فرويد حول «الوعي واللاوعي»، على المستوى الفردي، ومفاهيم كارل يونغ حول «اللاوعي الجمعي»، القائم على رموز الأساطير البدائية والمواجهات الأولى للإنسان مع الطبيعة، والمتوارثة عبر الأجيال. نتجاوز كل هذا إلى مفاهيم «الوعي الكوني» الشامل، حيث الكون بمليارات مجراته وعوالمه المتعددة يغدو وعياً حياً شاملاً، و«الوعي البشري الفردي» ما هو إلا جزء منه.
نتجاوز مفاهيم داروين حول «نظرية التطور» التقليدية، مع تعديلاتها المُحدثة، إلى وقائع «الاستنساخ البيولوجي»، ونرمي معها القضايا الأخلاقية التي تثيرها، بإمكانية خلق أجيال جديدة محسّنة وأذكى، أو تكرار النسخة الفردية إلى متشابهات بقدر ما نرغب. بل ونتجاوز كل ذلك إلى استنساخ الوعي الفردي ذاته على وسائط إلكترونية، وبالتالي إلى إمكانية إلباسه لكيانات جديدة، بيولوجية أو غير بيولوجية.
نتجاوز مع «النظرية النسبية»، و«النظرية الكوانتية»، ولغات الرياضيات الجديدة المرتبطة بهما، عوالمنا القديمة، ونكتشف إن «الكون المنظور» بتلسكوباتنا الهائلة لا يتجاوز سوى الـ (5%) من حجم الكون الكلي، والـ (95%) الباقية مجهولة، نسميها تجاوزاً «المادة المظلمة» و«الطاقة المظلمة». بل إن الواقع الذي نعيشه هو ما يلاحظه الوعي، فيخرجه حدثاً محدداً من لا نهائية احتمالات، تخفي أكواناً متوازية أو متعددة، تتوالد باستمرار من «حقول العدم الكوانتي الحية».
نتجاوز يقينيات الأساطير الدينية الاستيهامية؛ «إله يجلس مثل سلطان على عرش تحمله ملائكة»، وطوباويات الفلسفات والرؤى الإنسانية من بقايا مفاهيم «الحداثة»؛ مثل «الاشتراكية» و«الشيوعية»، إلى «اللايقينيات» و«العلاقات السائلة»، المرتبطة بمفاهيم «ما بعد الحداثة». وبعض دلائلها تحطم الروابط الاجتماعية التقليدية، مثل مؤسسات العائلة والزواج، وتحول الروابط الاقتصادية التقليدية القديمة إلى العولمة، وما بعدها، بتوحشاتهما.
أقول نتجاوز حالياً، لأننا سنتجاوز لاحقاً وبشكل مستمر كل ما نبنيه من يقينيات جديدة، لتغدو من جديد عابرة، فالتغيرات الجذرية العميقة في حياتنا لا تتوقف، بل وتتسارع أكثر فأكثر. ونحن، على سبيل المثال، لا نعرف إلى أي مجهول سنمضي مع «عوالم الروبوتات» القادمة، وكيف ستنتهي معها إنسانيتنا. بالتأكيد، قبل أن ندرك ما قد يحدث، فإن الحروب الصغيرة والكبيرة، المتناثرة هنا وهناك في عالمنا، عبر تاريخ طويل من سفك الدماء لا ينتهي، ستغدو حرب نووية مدمرة للبشرية ولكوكب الأرض، يكفيها كبسة زر من زعيم دولة نووية مجنون، وقد أصبحوا كُثر في عالمنا المعاصر. هذا إذا لم تدمر كوكب الأرض كارثة بيئية، نسببها نحن بجشعنا اللا محدود لثروات الأرض المحدودة، التي تؤمن التوازن البيئي لكوكبنا.
في عوالمنا هذه، المتغيرة باستمرار، تصبح أدواتنا ومناهجنا، المعرفية والفكرية والثقافية، المتداولة حالياً قاصرة عن فهم التحولات العميقة في حياتنا الإنسانية المعاصرة. وبالمثل تصبح أيضاً اللغة المرتبطة بها قاصرة بالتالي على التعبير عنها، هذا إن لم تقم بتشويه الوقائع والرؤى. على الرغم من إن اللغات الإلكترونية المبتكرة حديثاً تستطيع السيطرة على كثافة الإنتاج اللغوي، وإن بشكل نسبي، وعلى الرغم من إن اللغات الرياضية تحاول تفكيك بعض البنى المعقدة للوجود، من أجل محاولة فهمها، إلا إن كل هذا ليس سوى شكل آخر للتعبير عن هذا العقم في فهم التحولات. لا تكمن المشكلة هنا في اللغة كمبنى وتراكيب، بل في «المعنى» الذي تحمله، وقدرته التطورية على التلاؤم مع المتغير، عبر مناهج تفكير جديدة، من أجل الفهم كطريق للسيطرة والقدرة على البقاء.
بالأصل إن فهم الإنسان قاصر على فهم الخماسية المعرفية «الوجود – الكون – العالم – الطبيعة – الأنا»، لأن بنيته البيولوجية والنفسية نشأت وتتطور باستمرار بالارتباط مع البيئة المحيطة به، كي يتكيف معها، لا أن يتجاوزها. ومَن لا يتلاءم معها يفنى ببساطة؛ لأنه يصبح خارج الدورة الطبيعية للحياة التطورية. يحدث هذا بغض النظر عن أن الأدوات والتقنيات المبتكرة من قبل الإنسان، من أجل السيطرة على البيئة حوله، تبقى ضمن هذا الإطار المحدد. واللغة نفسها، كأداة، كابتكار إنساني نفسي – ثقافي، لا تتجاوز البنية التطورية المحددة في بيئتها، أي إنها لا تكشف خرقاً خارج إرادتنا. هذا بغض النظر عن وظائفها ضمن الأطر الاتصالية والتوثيقية، وعن قدرتها على بناء عوالم استيهامات كوقائع جديدة ملموسة (كما في الشعر خاصة، والأدب بعامة، أو حتى في لغة الصورة، وفي أحلام اليقظة...).
عندما نقول إن هناك شيء ما؛ بنى، وجود، استيهام... تقع خارج الرؤى، خارج الواقع، خارج الخيال، فنحن نلجأ من جديد إلى لغتنا، المؤطرة ببنيتنا النفسية، للتعبير عن إشكاليتنا العاجزة عن كشف ما نسميه لغوياً «ما وراء الوقائع» و«ما وراء الوجود»، العاجزة بالضبط عن كشف شيء غير مدرك بحواسنا أو استيهاماتنا مباشرة. وهي بالنتيجة ومن جديد مصطلحات لغوية للتعبير عن حدث غير موجود فعلياً، بغض النظر عما يتضمنه التعبير عنه من تراكم معرفي تخيلي – نفسي، ودون إشكالية الحديث عن مدى فهمنا بالأصل لمصطلحات مثل «الوجود» و«الواقع»، وبالتالي «ما وراء».
ندور دائماً بتساؤلاتنا في الحلقة المفرغة ذاتها، شيء ما يشبه أحد مبادئ الفيزياء الكوانتية؛ نحن نعرف ما نعيه فقط، وما نعيه هو الحدث الواقعي المُدرك بملاحظتنا له، كواحد من سلسلة احتمالات لا نهائية متضمنة في «العدم الكوانتي». لكن كل ما نعيه بالنتيجة (مباشرة أو استيهاماً) كاحتمال يبقى في حدود قدراتنا التطورية، بيولوجياً ونفسياً، ويمكن التعبير عنه فقط بلغتنا (سواء لغة الكلمات أو لغة الصور أو أي أشكال لغوية تعبيرية أخرى)، ضمن قدراتنا التطورية.
ضمن هذه الأطر المطروحة أعلاه، تبدو الأسئلة الوجودية التقليدية (من أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ وإلى أين؟) دون معنى، على الرغم من الجهد التراكمي الفلسفي – التاريخي، الذي تتضمنه. وهي نشأت بالأصل للتعبير عن إشكالية محاولة فهم وجودنا، فقط في إطار معارفنا التقليدية المحدودة للخماسية المعرفية «الوجود – الكون – العالم – الطبيعة – الأنا». بالعكس، تتطور المعطيات الجديدة حالياً وباستمرار باكتشافات علمية وتقنية مذهلة تتسارع في كافة المجالات، وتغير من طبيعة فهمنا المعرفي بطريقة أكثر تقدماً. وهو ما يتطلب بالتالي لغة ومناهج ورؤى أكثر جرأة وذكاء كأدوات للعمل بها، بسبب قصور القديمة منها.
يمكن كسر إلغازية الأسئلة الوجودية التقليدية الكبرى بطرق تفكير ومناهج ثورية جديدة، والنظر إلى الوجود بطرائق مغايرة، مما يستدعي رؤى فلسفية مبتكرة أمام هذه المعضلة. لكن المسألة تستعصي بصورة معقدة جداً عند النظر إلى «المنظومة الدينية» وكسر يقينياتها، على الرغم من تخلخلها إلى حد السقوط أمام الاكتشافات العلمية العميقة المتسارعة. تكمن الإشكالية في أن هذه المنظومة أصبحت مغروسة في «اللاوعي الجمعي»، عبر تاريخ إنساني تراكمي طويل، وتتجدد بارتباطها بالسلطة التي تستغلها كأداة للسيطرة، مما يصعب التخلي عنها.
كانت «المنظومة الدينية» قد ابتعدت منذ بدايات العصر البطريركية عن أصولها الروحانية البدائية (بغض النظر عن يقينياتها السابقة، المحددة باستيهامات الأسطورة وممارساتها الطقوسية العبثية). واكتست مع الزمن البطريركي أشكالاً إيديولوجية قمعية، مرتبطة ببنى السلطات الحاكمة، المسيطرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وغدت غطاء لصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية، تُحسم بتوحش السيف، فيما تحول كَهَنَتُها إلى أدوات إيديولوجية لفرض إرهابها.
تبقى الأديان هي المسيطرة حالياً بسطوتها السلطوية على المجتمعات المتخلفة، خاصة تلك التي ما تزال تعيش بنى «الاستبداد الشرقي»، وأشكال ما قبل الحداثة، المستندة على الطائفة، والعشيرة، والعائلة (وحالياً يُضاف إليها العصابة، أو المافيا بمعنى معاصر). وأفراد هذه المجتمعات لا يجدون أنفسهم إلا في سياسة القطيع المازوشي، الذي يبحث عن تأليه زعيم سادي له (جنرال، ملك، سلطان، جهادي، شيخ طائفة، رأس عشيرة أو عائلة، قائد ميليشيا...). لكن التبريرات الأسطورية الغيبية، اللا عقلانية واللا منطقية، التي تقدمها حالياً الأديان، كمسلّمات يقينية لتبرير الوجود وما بعده، انهارت بالكامل علمياً في عصرنا. وتحولت أساطيرها إلى تخريفات، لا تتناسب حتى مع حكايات الطفل المعاصر، الذي تستهويه الآن الألعاب الرقمية، بعيداً عن حكايات الشخصيات الأسطورية الحكائية، حتى ضمن قصص قداستها الترهيبية. في حين تنافس المنظومات الأخلاقية الوضعية الحالية، بقوانينها المعاصرة، مفاهيم الثواب العقاب الدينية، بل وتزيحها عن المشهد بمقدار تقدم المجتمعات.
سقطتِ «المنظومة الدينية» بالكامل، منذ عصر التنوير، بسبب تخلف أساطيرها أمام الاكتشافات الهائلة للعلوم والتقنيات. وعلى الرغم من إن الإله – أي إله – هو نتيجة استيهامات مَن يخلقه، إلا أن صورته بأشكاله الميثولوجية القديمة لم تعد مقبولة بسبب بساطتها، بل وبتلقي قداستها حالياً بسخرية معلنة أو مبطنة. على سبيل المثال، فإن صورة إله يجلس على عرش، تحمله الملائكة في السماء السابعة، هي صورة مستقاة من عروش الملوك والقياصرة التي نشأت في زمن ظهور الأديان وتطورها في عصرها البطريركي.
الأرض هي واحد من ثمانية كواكب، تدور حول نجم، نسميه الشمس. الشمس هي نجم من مليارات النجوم في مجرتنا «درب التبانة». مجرة «درب التبانة» هي واحدة من مجموعة مجرات «المجموعة المحلية». مجرات هذه المجموعة هي واحدة من مجموعة أضخم، تُسمى «عنقود العذراء». وهذا العنقود هو جزء من مجموعات العنقود الفائق «لانياكيا». و«لانياكيا» هي واحدة من عناقيد فائقة تشكل بعضاً من الكون المنظور. بالمحصلة يحوي الكون المنظور مليارات المليارات من المجرات، لا يمكن للعقل وبلغاته الرياضية التجريدية أن يحسبها أو حتى يتخيلها. يضاف إلى ذلك إلى أن تسارع تمدد «الانفجار الكوني – بيغ بانغ» يتجاوز سرعة الضوء، فلا نعرف ماذا يوجد وراء نقطة التفرد هذه؛ «أفق الحدث». وبعض ما يمكن التقاطه بتلسكوباتنا من ضوء أو إشعاعات راديوية كله لا يشكل سوى (5%) فقط من الكون.
في هذا الكون، غير القابل للتصور الإنساني باتساعه وتعقيدات بُناه التكوينية، لا مكان للإله التوحيدي (اليهودي، المسيحي، الإسلامي)، ولا لأي إله ديانة أخرى. مثل هذا الإله لم يعد يتناسب حتى مع «مملكته الأرضية» الجاهل بها، كما تظهر ذلك كتبه المقدسة. وهي مرتبطة حصراً باستيهامات الإنسان القديم التي جسدها أساطير خرافية غيبية، في إطار معارفه التقليدية، وعكسها في خلق جميع آلهته، بمَن فيهم الإله التوحيدي.
احتاج عصر التنوير الأوروبي بثوراته العلمية وتقدمه الفكري إلى صراع تاريخي طويل مع الكنيسة من أجل إزاحتها من المشهد السيادي في المجتمعات الغربية. وقد فشلت محاولات الكنيسة بقتل العلماء وحرقهم لإبقاء الكرة الأرضية مركزاً للكون، حتى لا تخالف أسطورة التكوين التوراتية، كرمزية لتمسكها بيقيناتها الدينية. ولم تعترف ببعض الحقائق العلمية مجبرة إلا بعد تحول كنائسها في نهاية القرن العشرين إلى متاحف فلكلورية، واكتشاف شذوذ رهبانها باغتراب قوانينها عن الحياة الإنسانية. وانتهى الأمر بتحول المجتمعات الغربية إلى العلمانية، في حين غدا الدين أحد المستحاثات فيها.
على الرغم من انكسار الرؤى اليقينية في الأديان التوحيدية الثلاث علمياً، إلا منظومتها ما تزال فاعلة كغطاء ديني – إيديولوجي – أسطوري في اليهودية والإسلام. تحاول إسرائيل استغلال فكرة قيام «مملكتها التوراتية» لفرض توسعها الاستيطاني العنصري الاستئصالي، في منطقة تعجّ بحضارات متراكمة تاريخياً، لشعوب تحمل ميراثها منذ العصور القديمة وحتى الآن. تحاول ذلك دون وجود سند تاريخي لرؤيتها التوراتية خارج الحكايات الدينية الأسطورية. وعلى الرغم من انكشاف استيهام إلهها التوراتي علمياً وسقوطه أخلاقياً، فهي ما تزال تستغله لتغطية إيديولوجيتها العنصرية، وفي الوقت نفسه تقدم نفسها كغطاء لامتدادات الغرب، لتصبح أحد أدواته في السيطرة على المنطقة. يتحول الدين اليهودي إلى أداة لتحقيق أهداف إيديولوجية سياسية، تُجير للسيطرة على أرض موعودة من إله موجود فقط في الاستيهام البشري.
لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمنظومة الدينية الإسلامية، المستندة في يقينياتها الوجودية في نشوء العالم بالكامل على «سفر التكوين» اليهودي. وعلى الرغم من انكشاف بنية إلهها، بجذوره اليهودية، عارياً أمام الاكتشافات العلمية المتتالية والمتسارعة، فهو ليس أكثر من إله بداوة متوحش، متعطش للدماء. وهو يناسب عشائر الصحراء المتنقلة، في العصور القديمة، التي كانت تعيش بشكل أساسي على الغزو والسلب والنهب...
لكن على الرغم من ذلك ما تزال المنظومة الدينية الإسلامية تعيش في استيهامات مجموعات واسعة من الناس، لا كقوة روحانية، وإنما كغطاء لصراعات سياسية واجتماعية، سواء مع الآخر الغربي، أو الآخر ابن منطقتها. هي أداة في صراع متوهم لشرق إسلامي مع الغرب العلماني المتقدم، الذي أزاح الدين من مجتمعاته، وهو المنتصر، الذي يسيطر على العالم بقوته، ليس فقط العسكرية، بل وأيضاً الاقتصادية والعلمية والثقافية. وتشكل هذه المنظومة الدينية أيضاً غطاء صراعات إقليمية بين الطوائف والنحل الإسلامية المختلفة؛ السنة والشيعة والكورد والدروز والعلويين والإسماعيليين، بتقسيماتها المختلفة، على مكاسب سيطرة سياسية. في حين تحولتِ الطقوس الدينية بتكراراتها العبثية، في إطار هذه السياسات، إلى أدوات تنميطية للسيطرة على أفراد القطيع، وتوجيههم نحو التوحش لسفك دم الآخر باسم المقدس.
كانتِ الأرض، في سفر التكوين التوراتي، مركز العالم (لم تكن تستخدم مفردة الكون ذات المعنى المعاصر بدلالاتها الحديثة)، وارتبطت بالتالي الرؤى المعرفية الدينية، وحتى لغتها التعبيرية اللاهوتية، بهذه المركزية الأسطورية. عندما أزاح عصر التنوير هذه المركزية، أزاح معها الإله، ومناهج الرؤى المعرفية اليقينية، ولغتها اللاهوتية، المرتبطة بتلك الحقبة المتخلفة. مع عصر التنوير تتشكل مناهج معرفية دقيقة بعلميتها، تعتمد المراقبة والتجريب، ولها لغتها الخاصة الدقيقة بها، التي تعبر عن مدى التطور العلمي والفكري، الذي تم الوصول إليه. كانت ضربة قاصمة للأديان، خاصة في مجال عوالمها الماورائية، ومفاهيم الحتمية والقدرية، والخير والشر، المرتبطة بها.
مع «الحداثة» بعقلانيتها وتنويرها، والمفاهيم المرتبطة بها، خاصة تلك المتعلقة ببناء دولة القانون الحديثة، انزاح «الإله» نهائياً من موقعه المركزي في العالم، بإطاره اللاهوتي القديم، ليذهب إلى النسيان، ويحل مكانه الإنسان في مركز الكون كله. هذه الثقة الكبيرة بالإنسان وعقلانيته هي التي أنتجت، منذ بدايات القرن التاسع عشر، سلسلة من «الفلسفات الإنسانوية الطوباوية»، التي ينتهي التاريخ معها بالتساوي بين الناس وتحقيق رفاهيتهم، وعلى رأسها «الماركسية» وقرينتها «الشيوعية». في حين اشتد الصراع على الأرض اقتصادياً بين الاشتراكية والرأسمالية، الذي انتهى بنجاح ساحق للثانية، وتطورت من رأسمالية الدولة إلى رأسمالية عابرة للقارات. ثم لتنتقل بعد ذلك إلى العولمة، التي هي في جوهرها «الأمركة»، وقد توسعت لتنميط «الاستهلاك» كأسلوب حياة عالمي.
مع تطور البنى الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المتقدمة، من «العولمة» إلى «ما بعد العولمة»، فإنه يكون قد تم الإعلان عن الدخول في عصر «ما بعد الحداثة»، لا كتطور للحداثة، بل كنقيض لها ومُدمر لبناها. ومعها ستحل «اللايقينية» و«العلاقات السائلة»، حتى في الحياة الاجتماعية، التي ستحطم بشكل خاص مؤسسات الزواج والعائلة التقليدية. وستنقل نوعياً مفاهيم الاستهلاك من «الإنتاج المادي»، المرتبط بالاحتياجات الأساسية للحياة، إلى «الإنتاج اللامادي»، المرتبط بكماليات المواد السمعية – البصرية الإلكترونية. وهذه المنتجات الأخيرة، بدءاً من الهاتف المحمول، وليس انتهاء بشراء «أوهام الصورة» واستهلاكها، ستصبح هي الأساسية للحياة المعاصرة، بل لا يمكن لحياة الإنسان الاستمرار بدونها. في هذا العالم «الما بعد الحداثي» يتحول الإنسان إلى مجرد «برغي» في ترس آلية العمل، وأداة نهمة للاستهلاك. وبعيداً عن مفاهيم العلاقات الإنسانية، سيتحول إلى «فردانية شخصانية» مكتفية بذاتها. مع «ما بعد الحداثة» ستنكشف هشاشة الإنسان أكثر فأكثر، وتنزاح العقلانية لتوحش «رأسمالي ما بعد عولمي»، ويفقد معها نهائياً موقعه المركزي؛ «مركز العالم»، أو «مركز الكون».
لكن الضربة القاصمة لمركزية الإنسان في الكون، وتأكيد هشاشته فيه، ستأتي من الاكتشافات الكونية الهائلة المذهلة، مع «الفيزياء النسبية»، و«الفيزياء الكوانتية»، وبمساعدة المراصد الأرضية والتلسكوبات الفضائية، الضوئية والراديوية. هذه الاكتشافات تجعل من شمسنا الأرضية نجماً بين مليارات النجوم في مجرة صغيرة، هي واحدة من مليارات المجرات، في كون لا يستطيع خيال الإنسان استيعاب القسم الصغير المرئي منه، الذي لا يتجاوز (5%) من حجمه المفترض. سيفقد الإنسان مركزيته الكونية، بالنظر إلى فقدان مجموعته الشمسية أهميتها في الكون، ليتم الحديث الآن ليس فقط عن الكون، بل وأيضاً عن «الأكوان المتعددة» و«الأكوان المتوازية». ويترافق ذلك أيضاً التأكيد على حتمية وجود كائنات فضائية، تختلف بناها وتركيباتها عن بنية الإنسان الأرضي، ووجود حضارات كونية متقدمة حتى على مستوى المجرات.
وإذا كان الغرب تخلى عن منظومته الدينية المسيحية منذ عصر التنوير، في خضم التحولات الرأسمالية والعولمية، فإن المجتمعات الشرقية دخلت في عصر العولمة بشكلها الاستهلاكي فقط، لكنها بقيت تعيش جذرياً في بنى «الاستبداد الشرقي»، و«ديكتاتورية العسكرة»، و«توحش جهادييّ الصحراء». لهذا تتواجد «انفصامية جمعية» شديدة، على المستوى الحياتي اليومي والنفسي، لدى أفراد هذه المجتمعات، تعبر عن تمزق شديد في اللاوعي لديها، بين مباهج حياة الاستهلاك، لكل ما يتم استيراده من منتجات الغرب «الما بعد الحداثي»، وبين تقاليد العنف المتوحش «الما قبل الحداثي»، المتأصل فيها تاريخياً (بمعظمه على أرضية بداوة دينية).
منذ عصر التنوير الغربي الحداثي، تم رفض أسطورية المنظومة الدينية، بناء على المكتشفات العلمية الحديثة، خاصة الكونية والبيولوجية منها. ومع عصر ما بعد الحداثة الغربي، أصبح يتم رفضها لاعتبارات جديدة، متعلقة بالمفاهيم المعاصرة، المرتبطة بمبادئ حقوق الإنسان وحريته؛ الديمقراطية، حق العيش بأمان وكرامة، المساواة بين الجميع أمام القانون، حرية التجمع والتعبير، احترام شديد للخصوصية الشخصية، حرية المرأة، حقوق الطفل، حق الرعاية الطبية، حرية «مجتمع الميم»...، والأهم من هذا إن السلطة التنفيذية في الدولة هي منتخبة لفترة محددة، وخاضعة للمحاسبة أمام السلطة التشريعية المستقلة عنها بالكامل. مع النظام الانتخابي الديمقراطي، يختفي الحاكم المستبد إلى الأبد؛ لا ديكتاتور عسكري، لا أمير جهادي، لا زعيم عشيرة أو طائفة... إنما حاكم منتخب بطريقة ديمقراطية، ولفترة محدد بالقانون.
لكن حرية الإنسان في هذه المجتمعات المتقدمة ليست مرتبطة فقط بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وإنما أيضاً بالإحساس الشديد بشخصيته الإنسانية المتفردة، وخصوصيته الذاتية. هو لا يخضع لأي سلطة بشرية، بل فقط لسلطة القانون، ويعيش حريته بالكامل، مهما كانت منفلتة، بشرط ألا يؤذي نفسه، ولا يزعج الآخرين، ضمن ضوابط تحكم الحياة العامة. حتى أنه ينفلت من عقلانية الحداثة وضوابطها الأخلاقية الصارمة، فيرمي بمؤسسة الزواج والعائلة خلفه، ويعيش «متعة الحب السائل» بوقتيته وبحثه المستمر عن الجدادة، دون أي التزامات تقليدية اجتماعية أو أخلاقية. بالمقابل تلتزم الدولة بتربية الأولاد خارج هذه المؤسسات التقليدية، فيما لو تخلى الأهل عن أولادهم لسبب ما، أو لم يعودوا مؤهلين لرعايتهم.
ومقابل استعباد الإنسان اقتصادياً من قبل آلية «النظام ما بعد الرأسمالي»، يتم تحريره بالمقابل من أي التزامات عائلية أو أخلاقية أو حتى رسمية تجاه المجتمع أو الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الزواج وضغوط الكبت الجنسي، مع التركيز على حرية المرأة بالذات، المهمشة تاريخياً. ومقابل استنزافه جسدياً وروحياً، يسمح له بممارسة حياة المتعة بلا حدود (الحق المقدس بالعطل الطويلة المدفوعة، حرية العلاقات الجنسية دون أي ضوابط، المخدرات دون إيذاء النفس...)، وينطبق هذا على المرأة مثلها مثل الرجل. ويتم الحديث عن الميزات الإيجابية للعزلة، وللحياة الفردية للإنسان في مملكته الخاصة، دون أي ارتباطات. تقوم الآلة الرأسمالية بتحرير الإنسان من كل هذه الضغوط حتى يصبح متفرغاً لعملية استنزافه بالطاقة القصوى التي يمتلكها.
تشكلتِ الحقوق العامة والحريات الفردية الشخصية في العالم الغربي عبر نضالات قانونية وحقوقية تاريخية طويلة، وأصبحت ركيزة أساسية في بنية «الذهنية الغربية». ويتم النظر إليها بالارتباط مع التقدم الحضاري والإنساني لمجتمعاته، خاصة على المستويات الاقتصادية. يتحرر الإنسان الكامل من بقايا المنظومات الأخلاقية الدينية التقليدية، بل وحتى العقلانية الحداثية.
في المقابل يغرق العالم المشرقي أكثر فأكثر في تخلفه الحضاري، ويتراجع إلى أسوء أشكال التجمعات السياسية محافظة، المرتبطة بعالم ما قبل الحداثة؛ الديكتاتوريات العسكرية، التعصب الديني، الطائفية، العشائرية، العائلية الإقطاعية، والمؤطرة جميعها بمفاهيم «المافيات الرسمية» المعاصر. لا تستطيع هذه البنى ما قبل الحداثية أن تعيش إلا على أرضية النزاعات، لأنه بدونها ستفقد مبررات وجودها، وهو ما يستدعي حروب دائمة ومستمرة، سواء الأهلية منها أو العابرة للحدود. وهنا تشكل المنظومات الدينية غطاء رسمياً ضرورياً لجميع هذه الصراعات، لجعل توحش أفعالها مبرراً بالقداسة، باسم «الزعيم – الإله»، أو «الإله – الزعيم»، لا فرق.
لا يمكن هنا إجراء مواجهة أو حتى مقارنة بين الذهنية المشرقية والذهنية الغربية، والبحث في أي منها من هي الأفضل أخلاقياً أو نفعياً، فكل واحدة منها نشأت وتطورت في بيئتها وباشتراطات تاريخية تراكمية خاصة بها. بالتالي، فالأحكام في هذه المجالات ليست إطلاقية، إنما نسبية مرتبطة باشتراطات تاريخيتها. على سبيل المثال، إن فقدان المرأة لعذريتها قبل الزواج في مجتمع مشرقي مرتبط بشرفها، من وجهة نظر ذكورية – بطريركية، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى قتلها «غسلاً للعار». في حين إن مثل هذا الحدث في مجتمع غربي يعبر عن حرية المرأة وحقها في ممارسة الجنس دون قيود، مثلها مثل الرجل. بل وتقوم مؤسسات الدولة، بدءاً من المدرسة الإعدادية، بتثقيف الناشئة وتوعيتهم جنسياً، وبل وتعليمهم كيفية تجنب الحمل في هذه الممارسات، وتأمين الأدوات المساعدة لهذا. هذه النسبية في الأحكام هي التي تقرر إمكانية القبول بأي ظاهرة ما في إطار مجتمعها، لا رفضها من قبل رؤى مجتمعات أخرى.
لكن على الرغم من التعارضات والتباينات، أحياناً الجذرية، بين كثير من عناصر الذهنية الغربية وعناصر الذهنية المشرقية، إلا أنه تبقى هناك قيم عليا وقيم سلبية، على المستوى الإنساني، تنفصل عنهما. إن حقوق الإنسان وحرية المرأة على سبيل المثال هي مثال للقيم الإنسانية السامية العليا، وإن كانت ترتبط حالياً بوضوح بالمنظومة الغربية، في حين تحتقرها المنظومة المشرقية. لا تتعلق هنا القضية بالنسبية، وإنما بتراكم إنساني تاريخي لحقوق الإنسان في العيش بكرامة، وصل إلى تشكله في منظومة حقوقية متكاملة، محمية بالدساتير والمؤسسات التشريعية في العالم الغربي. بالمقابل، إن التعصب الديني والطائفي والعنصري في البنية المشرقية هو مثال لقيم إنسانية، هي بالتأكيد سلبية وسيئة، وتعبر عن احتقار للإنسان وإمكانيات إهدار دمه ببساطة دون وجود روادع أخلاقية وقانونية.
على الرغم من التمايز بين الذهنيتين، الغربية والمشرقية، فإن القيم الإنسانية السامية العليا، المرتبطة عملياً بالعالم الغربي، يمكن أن تتسلل إلى أفراد من العالم المشرقي، قرروا الخروج من سياسة القطيع، الذي يسير وراء الزعيم – الإله. ويتعلق هذا بالحديث عن حقوق الإنسان وقضايا الحرية.
إذا كان رفض المنظومة الدينية، بأساطيرها يتم منذ عصر التنوير بناء على الاكتشافات العلمية، الكونية والبيولوجية خاصة، فإن التطورات الفكرية والثقافية لما بعد الحداثة، المتعلقة بالإحساس بكرامة الإنسان وتمايز فردانيته، خلقت رؤى إضافية أخرى لتأكيد هذا الفعل الرافض. ويمكن هنا التركيز على سبيل المثال على منظومة «الإله التوحيدي – الإسلامي»، كنموذج لرفضها، عبر رؤية إنسان ما بعد حداثي، يستند من جهة أولى على الاكتشافات العلمية، ومن جهة ثانية على تفرد شخصيته المعاصرة، وتمايز ذاته الإنسانية.
ويمكن تلخيصها من وجهة نظر هذا الإنسان بالنقاط الأربعة التالية، كنماذج فقط:
النقطة الأولى:
لماذا عليّ الخضوع لسلطة إنسان حاكم؛ ديكتاتور أو جهادي أو زعيم أو مَن في مقامهما، وبأي حق أمتثل له مذلولاً، ومثله أيضاً لكائن استيهام أسطوري، ليس لدي أي دليل على وجوده، سوى مخيلة مريديه المتعصبين المريضة؟ لماذا ينبغي عليّ عبادة مثل هذه الشخصيات وكائناتهم المخيالية، عبر طقوس تكرارية عبثية يومية لا معنى لها، تؤدى في المنزل أو في معبد أو حتى باستعراضية في شارع، سوى التعبير عن الخضوع المذل لهما وإقلاق راحتي؟ هل هذه الشخصية وكائنها هما نرجسيان إلى حد أنهما بحاجة إلى تقديم فروض الطاعة لهما باستمرار بطقوس الاسترقاق الذليلة (على سبيل المثال الصلاة خمس مرات يومياً، وطوال الحياة، ما الفائدة العملية منها لمؤديها)؟ ألا تحتاج مثل هذه النرجسية المريضة، كتعبير عن عقلية مريضة انفصامية، إلى معالجة نفسية؟
النقطة الثانية:
إذا كان هناك كيان أو زعيم يعرض على الإنسان متعة دائمة في الطعام والشراب والجنس، بشرط أن يخضع له تماماً، ويعبده دون اعتراض، ويهدده في المقابل بعذاب شديد وسادي إن رفض أو تمرّد عليه، فإن هذا الكيان يمكن وصفه نفسياً بأنه مهووس بالسيطرة، ويمتلك نزعة سادية عميقة تدفعه للتمتع بتعذيب من يرفض الخضوع له. وكيف يكون حال كائن استيهام هذا الشخص، عندما يحول هذا الفعل إلى ديمومة لا تنتهي أبداً. تتحول فيها عنده «دار النعيم» إلى فيلم بورنو بذروة الإباحية، الجنس فيه متواصل بطاقة بشرية لا تنتهي، ويُزين المقام فيها بتقاليد بداوة شرقية متوحشة (فضّ بكارات نسوة باستمرار والتمتع بنزفها، إشباعاً لشهوة امتلاك جسد المرأة)، في حين تُحرم المرأة من هذا الحق (لا يستطيع عقل الرجل الشرقي – البطريركي مشاهدة تناوب عشرات الحوريين على امرأته، حتى في دار النعيم هذه).
بالمقابل، بماذا يستمع هذا الكائن، عندما مشاهدة ضحية تُعذّب باستمرار، بشويها مثلاًــ، كلما احترق جلدها، يتجدد لتتألم من جديد، في «دار العذاب»؟ هكذا، دون نهاية لفعل التعذيب عبر استمراره بالتجديد. ما هي المتعة المريضة التي يشعر بها هذا الكائن المريض بالسادية، عند مشاهدة عدد هائل من البشر يتلوون في النار طوال الوقت؟ ألا تحتاج هذه السادية المريضة، التي تعكس شخصية مبتكرها باستيهامه المريض، إلى معالجة نفسية مركزة، بعد عزله عن الناس حوله في مصح للأمراض العقلية؟
النقطة الثالثة:
لماذا تنشأ الحروب والصراعات، بالمجازر الوحشية المرافقة لها ودمار العمران، بشكل لا ينتهي، طوال التاريخ، وفي جميع بقاع العالم، ولن تنتهي أبداً حتى يتم دمار الجنس البشري بالكامل بحرب نووية؟ هل يحتاج هذا الكائن الأسطوري المسؤول عن خلق العالم (أم بالأحرى خالقيه) إلى هذا العدد اللانهائي من الأضحيات البشرية، التي لا يرتوي من دمائها؟ أم أنه ببساطة عاجز عن إيقاف هذه المجازر، لأنه لا يسيطر على عالمه... أو أنه بالأحرى غير موجود، وينبغي البحث عن أسباب هذه الحروب الدموية في مواضع أخرى، مثل غرائز الإنسان البدائية، المتأصلة فيه، على الرغم من تطوره في درجات الحضارة الإنسانية، وتُضاف إليها العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الصراعات بين المجموعات.
النقطة الرابعة:
لماذا يقوم الكائن الأسطوري بخلق تنوع هائل في المجموعات البشرية، عبر تاريخ طويل للحضارات، والمتمايزة اثنياً وثقافياً واجتماعياً، فتتشكل بينها العداوات الدائمة؟ وهي لا تكتفي بذلك، بل وتخلق كل مجموعة منها إلهها الخاص بها، تريد منه أن يدعمها في صراعها ضد الآخرين. في حين أن هذه الآلهة تتصارع فيما بينها على حق الألوهية الأعلى، تأكيداً لسمو جماعتها على جميع البشر. تخلف في صراعها عدداً هائلاً من الضحايا البشرية، بينما تبقى هي حية في مخيلات وعقول مريديها المريضين بتعصبهم. على سبيل المثال، فإن الإله التوحيدي اليهودي لم يستوِ على عرش العالم إلا بعد أن أباد جميع آلهة العالم القديم. أما الإله التوحيدي الإسلامي، فهو في صراع مستمر ودائم مع آلهة الأقوام الأخرى (بما فيها تلك التي تقول عن نفسها إنها تمثل الإسلام وإلهها هو الحق)، ولذلك لا تهدأ الحروب بين مريديه والآخر المغاير باسم الجهاد.
يمكن لهذه التساؤلات أن تحل واقعياً وفعلياً – بشكل مبدئي – بدلاً من الأسئلة الوجودية الفلسفية الكبرى (من أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ وإلى أين؟)، إذ تبدو أنها أكثر عملية في الاقتراب من طريقة فهم معنى وجودنا. وفي الإجابة عنها، يمكننا معرفة البعض من أسباب وجودنا، بهذه الأنماط الحياتية، بعيداً عن يقينيات «المنظومات الدينية» الأسطورية. بدلاً من ذلك، يمكننا الاعتماد على مناهج البحث العلمي وطرائق الملاحظة والتجريب في محاولة الاقتراب من فهم «وجودنا».
إذا كانت روحانية «المنظومة الدينية» أداة لمحاولة إيجاد الطمأنينة الفردية الشخصية، من خلال الإيمان بعالم ما ورائي، وتحاول في أحد مراحل تطور الحياة الإنسانية، إيجاد إجابات عن معنى الحياة، فهي تعبير عن تنوع ثقافي إنساني غني، خاص برؤاه الأسطورية. لكن عندما تتحول هذه المنظومة إلى أداة عنف دموية، كغطاء لصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فإنها تفقد جذورها الروحانية.
فقد «العالم المشرقي» روحانياته، بدمار دياناته القديمة التعددية واندثارها، وحدث ذلك بقدوم «الإله التوحيدي». وما بقي منها مسيطراً في منطقتنا هي الأديان التوحيدية الثلاث له، بجذورها العنصرية المشتركة. وإذا كانتِ اليهودية تميز «شعبها الموعود من الإله» من بين كل أمم الأرض، فإن جوهر المسيحية لا يعترف بالإسلام كدين تال له. بالمقابل، فالإسلام نفسه يعلي من آية ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، تميزاً له من بين كل شعوب الأرض، وأنه يمثل نهاية الأديان، وبالتالي يريد فرض وجوده بحد السيف، تحت مقولة «الجهاد». تحاصرنا أديان عنصرية، كل واحد منها يريد استئصال الآخر، هذا دون الحديث عن الهندوسية والسيخية والبوذية وديانات الشرق الأقصى. نحن الآن دون سند روحي بالكامل، حتى إن التيارات الصوفية الإسلامية (والصوفية بشكل عام)، المفترض أن تعطي معنى للأسفار الروحية، تحولت إلى طقوسيات استعراضية. ومقابل خوائنا الروحي، تطل دائماً أشكال البداوة المتوحشة تحت ستار الدين، وتحاول فرض وجودها بحد السيف.
أخذت روحانيات العالم الغربي بالتآكل شيئاً فشيئاً، خاصة مع نهوض «المجتمع ما بعد الصناعي»، وتحول الإنسان الفرد إلى برغي في آلة إنتاج ضخمة. حتى وصلت إلى حد الاندثار. تحل الآن مكانها القوانين الشديدة العقلانية بدقتها وصرامتها، ناظمة للحياة. حاول بعض الأفراد في النصف الثاني من القرن العشرين اللجوء إلى «غرائبية الديانات الشرقية»، خاصة الهندوسية والبوذية، في محاولة لإيجاد الخلاص فيها، واكتساب معاني روحية للحياة. لكن هذه المحاولات كانت فردية وباءت بالفشل. مع عصر ما بعد الحداثة، لم يفقد هذا العالم الغربي مرجعياته العرفانية والصوفية، بل وروحانيات الحياة اليومية. تفتقد علاقات الحب والصداقة والجيرة وزمالة العمل معانيها الروحية، تغدو علاقات دون مشاعر وعواطف، وتتحول إلى علاقات نفعية استهلاكية، تسيطر عليها مفاهيم «العلاقات السائلة»، المفتقدة للثبات والديمومة، وبالتالي ترتبط بوقتية حدوثها، فتفقد المعنى.
مع عصر «ما بعد الحداثة»، لم تنهار فقط يقينيات المنظومات الدينية، ومثلها عقلانيات الحداثة، بل وأيضاً روحانيات الحياة اليومية، التي تحولت إلى الخواء تحت ستار التقدم الحضاري. نحن بحاجة لإيجاد رؤى ومفاهيم، في إطار عالم ما بعد الحداثة المهيمن، وبالتالي لغة يومية وفلسفية تناسبها، كي تنقذنا من عالمنا البارد، الخاوي من الروحانيات وجفاف العلاقات الإنسانية. فقد الإله مركزيته في العالم مع عصر التنوير، ومن بعده فقد الإنسان مركزيته في الكون مع حقبة ما بعد الحداثة، واندثرا هما الاثنان كمفاهيم متمايزة. ونحن نعيش الآن بتيهان عبثي، لا يشعرنا فقط بالضياع والرعب، أمام كون هائل الاتساع بطريقة لا يتصورها العقل والخيال، بل وأيضاً أمام إبهام وغموض وجودنا، كذرة غبار فيه. وكي ننسى، نتلهى بثقافة الاستهلاك في آلية رتيبة تدمر أرواحنا، نفقد بها معها الإحساس بعلاقتنا ببعضنا البعض، الإحساس بالزمن، الإحساس بوجودنا.
نستخدم الآن مصطلحات جديدة، للتعبير عن واقع الاكتشافات الحديثة، التي بدأت تغزو حياتنا اليومية. والأهم هو إدراجها واندماجها في أدوات استخدامنا الإلكترونية اليومية (أقرب مثال الهاتف المحمول، الذي لا غنى لأي شخص عنه الآن). ثم أخذت تجد تعبيراتها في ثقافة منظومتنا السمعية – البصرية، خاصة في روايات وسينما الخيال العلمي، كتعبير عن الرؤى السائدة في عصرنا. بدأت هذه المصطلحات بالانتقال من تحديدها المباشر لحدث محدد، إلى استخدامها في سياقات ثقافية، بل وحتى فلسفية – فكرية، مندمجة في حياتنا، وبالتالي إعادة تشكيل فهمنا لما حولنا، بدءاً من حياتنا اليومية في عالمنا الأرضي، وليس انتهاء بتوسعنا في اكتشاف مجاهلنا الكونية. ينطبق هذا على العالم الغربي كما على العالم الشرقي. الحروب الوحشية، المميزة للعالم الثاني، أصبحت تدار الآن أكثر فأكثر إلكترونياً (الطائرات المسيّرة على سبيل المثال)، الضحايا فيها أكثر انتقائية (القتل الأنيق، التدمير الممنهج).
نستخدم الآن كثير من التعابير في هذا الإطار من مثل «الواقع الافتراضي»، «الحاسوب الكوانتي أو الكمومي»، «الروبوتات»، «الذكاء الاصطناعي»، «الكون»، «المجرات العنقودية»، «الكون المرئي»، «المادة المظلمة»، «الطاقة المظلمة»، «الأكوان المتعددة»، «الأكوان المتوازية»، «الثقوب السوداء»، «الثقوب الدودية»، «نظرية الأوتار الفائقة»، «الزمكان»، «السفر في الزمان»، «العودة إلى الماضي»، «العدم الكوانتي»، «الوعي الكوني»، «الكائنات الفضائية»، إلى جانب سلسلة طويلة من مصطلحات النظرية الكوانتية، التي تناقض القوانين العقلانية والسببية... لكن أهم هذه المصطلحات تعبير «المحاكاة» و«المحاكاة الكونية».
يكتسب مصطلح «المحاكاة الكونية» حالياً أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، في محاولة التعبير عن الشكوك بمعنى وجودنا، في إطار الأسئلة الوجودية الكبرى التقليدية، وذلك بناء على آخر المكتشفات العلمية، الكونية منها خاصة. يستخدمه عدد متزايد من علماء الكونيات المشهورين، والفلاسفة المستقبليين المميزين، يروجه مؤلفو روايات الخيال العلمي، ومخرجو أفلام الخيال العلمي، بل ولغرابته يصل إلى حديث الناس اليومي. تستند هذه النظرية، بناء على كثير من المعطيات الفعلية، خاصة الكونية والإلكترونية والرياضية، المندمجة بخيال فانتازي مجنون، إلى وجودنا البشري في قلب محاكاة كونية عملاقة، صممها لنا عقل كوني فائق الذكاء، أو حضارات كونية. وتجد هذه النظرية تأكيدات قوية خاصة بالارتباط مع الحديث عن وجود «كائنات وحضارات فضائية» بما يشبه اليقين العلمي.
مستفيداً من مفهوم «المحاكاة اليومية الإلكترونية» ودمجها في «الأبعاد الكونية» لنظرية الأوتار الفائقة، حاولت في روايتي «ترانيم التخوم» تأطير الحياة المعاصرة بفردانيتها وضغوطها النفسية في هذه الأطر العلمية. هي مزاوجة بين الأدب والرؤى العلمية – الثقافية المعاصرة، التي بدأت تسيطر علينا، وفي الوقت نفسه كتعبير عن الغربة الوجودية التي نعيشها، ليس فقط في عالمنا المادي المعاصر، بل وأيضاً في عالمنا الوجودي، فيما ينفتح أمامنا كون هائل الاتساع، لا تشكل حضارتنا الأرضية أكثر من ذرة غبار فيه. في هذه المحاولة يتم طرح أسئلة، خارج مفاهيم المنظومة الدينية وخارج مفاهيم منظومة حقبة الحداثة، وبالتالي في إطار ما يسمى «أدب ما بعد الحداثة».
أبدأ رواية لي بالعبارة التالية:
«أنا وعي كوني، أو ربّما محاكاة له... ذاتٌ مدركة من نزوة الاحتمالات. أعيش في عالم افتراضي، بل ربّما في حكاية، أو بالأحرى في حكاية محاكاة افتراضية. أنا وعيٌ، لا مادّي لا روحي، لا مكاني لا زماني؛ طاقة كثيفة، من دون تمركز أو تخوم، بقدرات لا محدودة، لكن لديّ مشاعر كونية، تعبيراً عن وجودي. لا يمكن لاستيهامات الكلمات، أو الصور، أو الأصوات، أو الإشارات، أو الرموز، أو التصوّرات الذهنية، أن تحيط بي، أو حتى تستشفّ شيئاً من كينونتي. أنتمي إلى كائنات ما بعد الأحلام، ما بعد الرؤى، خارج التوقّعات والإيحاءات، والتخيّلات والهلوسات».
أفكر هل هذه محاولة «لاواعية» لاكتشاف معنى وجودنا، عبر استخدام المزج بين الأدب والمفاهيم العصرية للمحاكاة الكونية. أم هو تأليه جديد لقوى كونية بلغة «ما بعد الحداثة – الروائية»، دون القدرة على التخلي في «اللاوعي» في استخدام مفردات المنظومة الدينية، وقوانين عالم الحداثة، خاصة قوانين السببية فيها.
تساعد المكتشفات العلمية الحديثة على حل كثير من المعضلات الحياتية ( تجعلنا نغزو الفضاء مثلاً)، لكننا نقف دائماً مهزومين أمام مسائل الموت والحياة.
أطرح تساؤلات، إذا كنا بحاجة إلى قوى كونية جديدة، نعبدها باسم المحاكاة الكونية، بعد انتهاء دور المنظومات الدينية؛ آلهة نخلقها من هواجسنا وخيالاتنا، كما فعلنا مع آلهة العصور القديمة، وإنما نعتمد الآن على معطيات علمية معاصرة جديدة. إلى هذا الحد إن الإنسان هو هش، يشعر بالتيهان في وجوده، ويبحث عن معنى روحي ما، يستند إليه، ويجعله يواجه رعب المجهول، يحاول إيجاد المعنى في اللامعنى. أم هي في النهاية لعبة اللغة، كنتاج نفسي – تطوّري لحاجات ثقافية، بالارتباط بإدراكاتنا المعاصرة، التي نشأت وتتطوّر في بيئة محدّدة. ونحن نحتاج في النهاية إلى أن نتكيّف ونتلاءم مع بيئتنا، لا أن نتجاوزها، حتى بأدواتنا التي نبتكرها، ومنها اللغة. بالتالي، هل هي حدود لا يستطيع تكويننا البيولوجي – النفسي، على الرغم من تطوّره، تجاوزها، لا كتشاف... اكتشاف ماذا؟