
د. سارا زيد محمود
كاتبة وأكاديمية
روایة "ميرنامه" النزعة القومية الكوردية من منظور أدبي
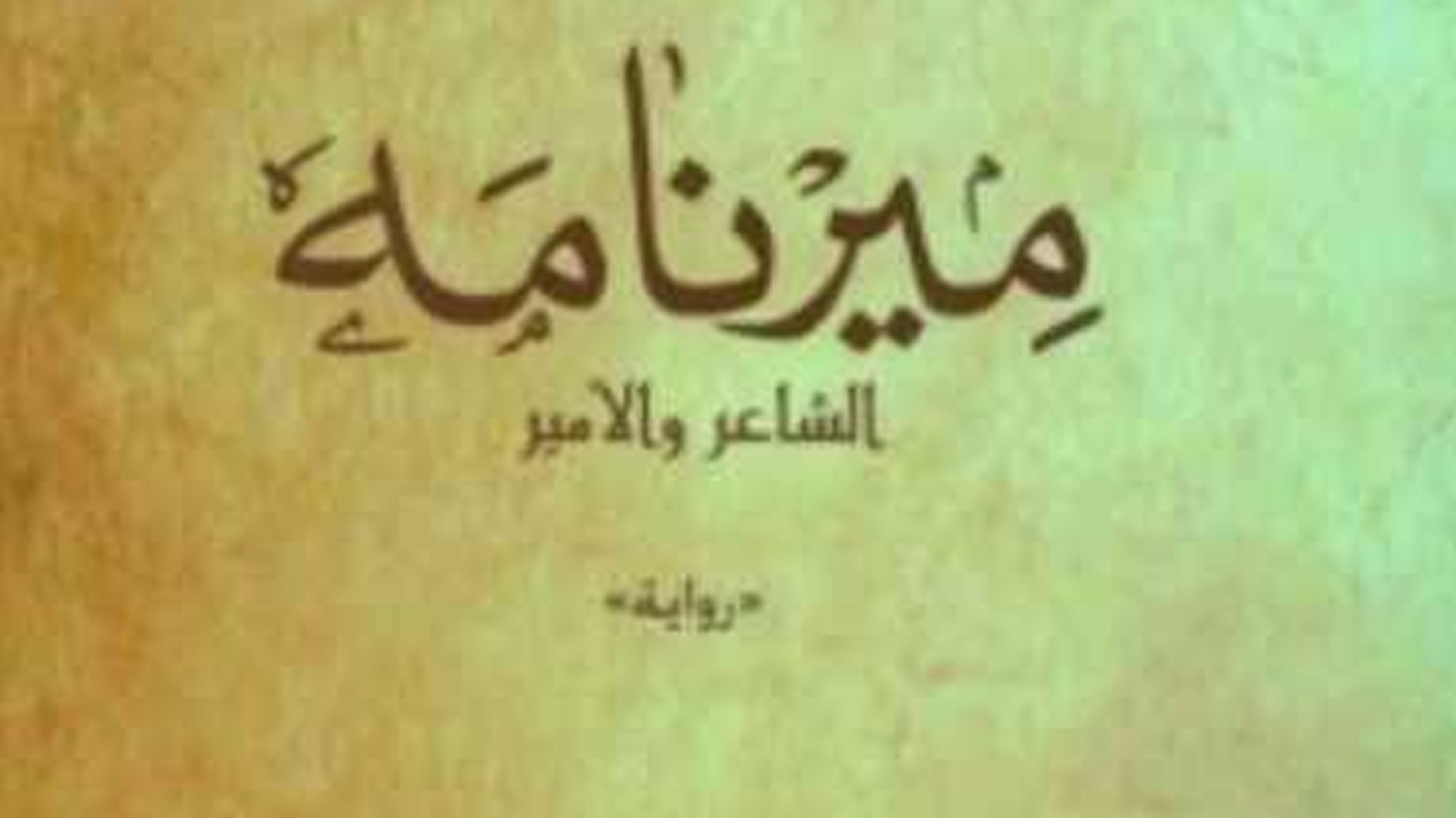
تُعد رواية "ميرنامه: الشاعر والأمير" لجان دوست عملاً أدبياً تاريخياً يتناول فترة زمنية عاش فيها الشاعر والمفكر الكوردي الكلاسيكي أحمد الخاني، الذي يُعد من أبرز المؤسسين للفكر الأدبي الكوردي، ومن الذين أسسوا لبذور القومية الكوردية. تدور أحداث الرواية في بلدة بايزيد، الواقعة على الحدود الفاصلة بين الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية، وتُسلط الضوء على واقع الكورد في تلك المدينة خلال تلك الحقبة التاريخية. تعتمد الرواية في بنائها السردي على أسلوب شعري يسترجع أحداث الماضي بطريقة تخيّلية تعتمد على خيال الكاتب في تشكيل رؤيته الإبداعية. تبدأ السردية باستحضار الماضي من خلال أصوات شخصيات عاصرت (الخاني)، سواء أكانوا من أصدقائه أم أعدائه الذين وقفوا ضد دعوته القومية، بسبب خطابه الوطني الذي سعى من خلاله إلى تمكين الكورد والانتصار لهم في وجه الفرس والترك.
من أبرز الشواهد على نزعة الخاني القومية، إصراره على الكتابة باللغة الكوردية، رغم تمكنه من الكتابة بلغات أخرى، إذ اختار الكوردية لتكون لغة رائعته الأدبية ((مم و زين))، في محاولة منه لإعلاء شأنها ومنحها قيمة ثقافية ولغوية. ويُنظر إليه بوصفه أول من نادى باستقلال الكورد وتأسيس دولة كوردية مستقلة عن الهيمنة العثمانية والصفوية. ويصف الراوي، على لسان الخاني، الأوضاع السياسية المضطربة في قوله: ((حينما كانت بريفان ما تزال في يد الفرس، وكانت مدن هذه البقاع مثل كرات تتقاذفها الصولجانات، ترتع فيها راية الفرس يوما وراية الترك يوماً. وفي النهار كان القزلباش يحكمون، وفي الليل يحكم السنّة. وكنا نحن المساكين مثل زورق مثقوب تتقاذفه أمواج الترك والفرس)) (جان دوست، ص143)، رؤية "الخاني" هنا تكشف عن نظرة نقدية حادة للصراعات الإقليمية في المنطقة، وتُظهر كيف تحولت حياة الكورد إلى رهينة لصراعات قوى لا تمثلهم. يستخدم جان دوست لغة شعرية وصورًا رمزية ليُجسّد العبث السياسي، والمعاناة الإنسانية، والهشاشة الوجودية لشعب واقع بين مطرقة ومِطرقة.
تنتمي هذه الرواية إلى جنس السرديات التاريخية التخييلية، إذ لا تتناول شخصية كلاسيكية ووقائع تاريخية واقعية فحسب، لكنها تعرضها من خلال تقنيات السرد الحديث، مثل تعدد الأصوات الروائية، وتوظيف اللغة الحيّة المتناسبة مع البيئة التاريخية التي تعود لقرون مضت. وتمتاز اللغة السردية بالقوة والرصانة، مع توظيف الرموز والدلالات، كرمز المطر الذي يهطل حبراً أسود بعد وفاة الخاني، في دلالة على غضب الطبيعة لرحيله، وعلى مكانته كمثقف موسوعي فريد في عصره.
تُبرز الرواية صراع الثنائيات التي شكّلت التوتر الدرامي داخلها: مثل: الحب والكراهية، الأنانية والتواضع، الخيانة والوفاء، الأعداء والمخلصين، والهوية الكوردية في مقابل محاولات طمسها. هذا التوتر يُعمّق من تصوير الاضطهاد التاريخي الذي تعرّض له الكورد، ويُجسّده السرد بمستويات رمزية متعددة.
وتظهر ملامح فكر الخاني القومي بشكل جليّ، يقول: ((لو أصغى إلىّ الأمير لجعلت من بايزيد دار علم كبيرة يأتي إليها الطلبة من أطراف كوردستان الأربعة ليدرسوا فيها، لو أطاعني لجعلت بايزيد تنافس تبريز وأصفهان وإسطنبول)) (جان دوست، ص188). كذلك ينتقد الخاني إهمال الحكام - الفرس والعثمانيين- للأدب والثقافة، إذ يقول: مع أن قلب خاني موطن للكنوز/ إلا أن أحداً لم يسأل عن جوهره (مم وزين، ترجمة جان دوست، ص39)، وهذا القول يدل على مدى مرارة وتهميش الثقافية والفكر في ذاك الزمن سواء على مستوى الفردي أو القومي، فالخاني يوجه نقدا لاذعاً للسلطات التي همشت الكورد ونظرت إليها نظرة دونية وسطحية.
تُصنف الرواية ضمن السرد التتابعي التوثيقي الخيالي، الذي يستند إلى وقائع تاريخية ذات صلة بالمجتمع الكوردي، وتكمن خصوصيتها الفنية في تقديم شخصية (أحمد الخاني) بوصفه المثقف المحوري في العمل الروائي. وقد استطاع الكاتب جان دوست أن يوظف موهبته الشعرية في سرد الأحداث، فامتزج السرد الشعري بالتجربة التاريخية والوثائقية، مما أضفى على الرواية طابعاً أدبياً ومُخيّلة عالية.
تميّزت الرواية التاريخية في هذا السياق عن غيرها من أنواع الرواية التخييلية بأنها تستند إلى وقائع وأحداث موثقة، يُعاد صياغتها عبر السرد الإبداعي. وهي، كما يرى بعض النقاد، تنتمي إلى النوع السردي الذي يسعى إلى ((إعادة بناء الماضي بطريقة تخييلية، حيث تتقاطع الشخصيات الحقيقية مع المتخيلة)) (يقطين، الرواية التاريخية،2005،ص144)، وبذلك تصبح الرواية التاريخية مادة جمالية ورمزية، تتجاوز التوثيق لتُعيد تمثّل الماضي بطريقة تُعزّز فهم الإنسان لحياته وهويته. ويشير بول ريكور إلى هذا النوع من التداخل بين الخيال والتاريخ بمصطلح (الهوية السردية)، حيث يلتقي السرد الأدبي بالمرجعية التاريخية في نقطة تفاعل تُشكّل وعياً جديداً بالتجربة الإنسانية، يُعبّر عنها السرد الروائي بأبلغ مما يُعبّر عنها التاريخ وحده.