
علاء الدين آل رشي
مدير المركز التعليمي لحقوق الإنسان
في الحاجة إلى إصلاح العقل السوري
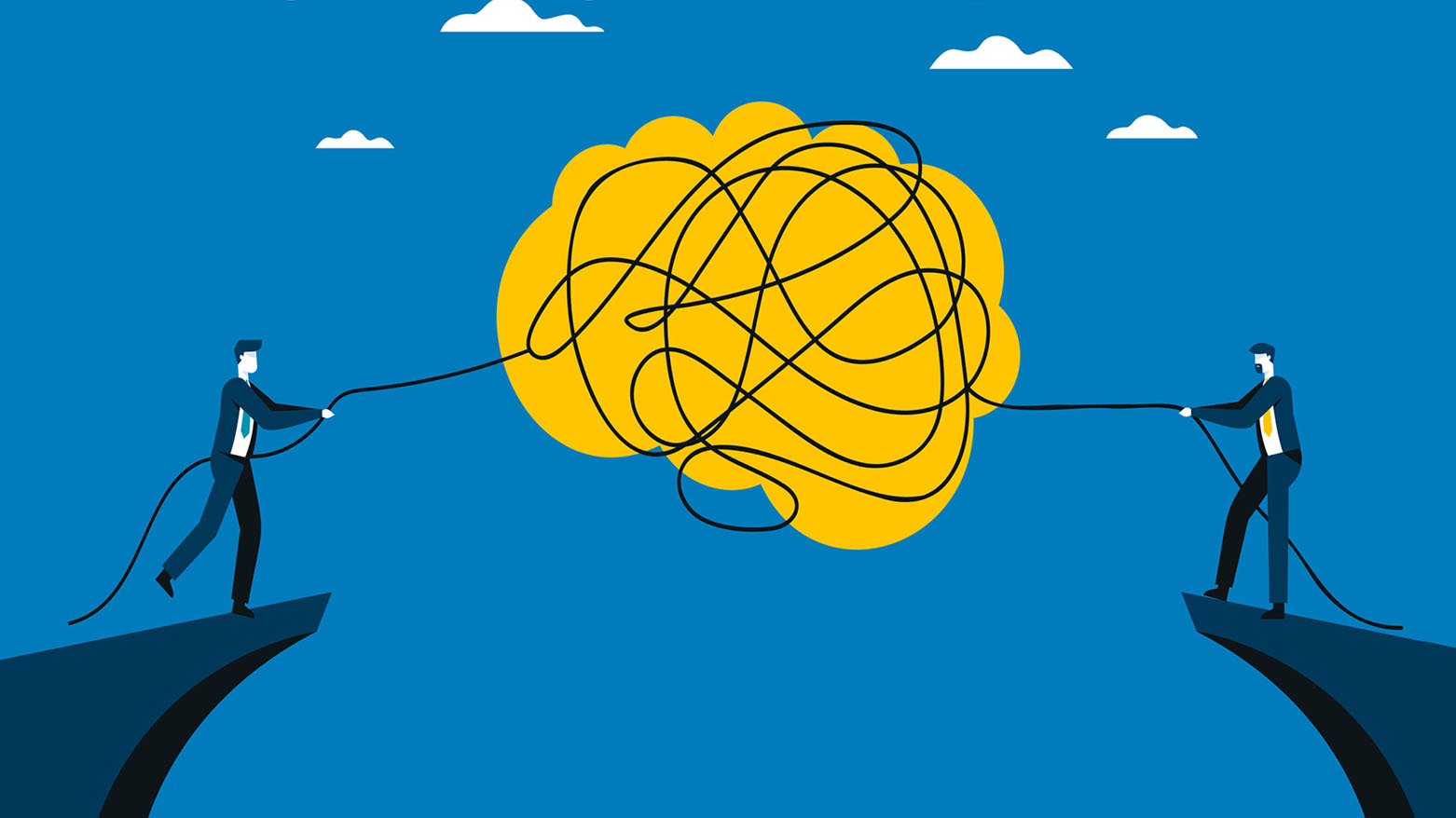
حين سألتُ أستاذي المبجّل أحمد معاذ الخطيب: ما الذي يمكن فعله وسط هذا الركام من الألم، وهذا الطوفان من التشويش؟ أجابني بعبارات ثلاث تكررت على نحو عجيب، حتى غدت وكأنها عهد مكتوب: الوعي، ثم الوعي، ثم الوعي... والصبر، ثم الصبر، ثم الصبر. مع أن إجابته كانت ردًّا عابرًا على سؤال لحظي، لكنها كانت تلخيصًا مكثّفًا لما نحتاجه للخروج من ظلمات التردي التي دخلناها، حين تخلى العقل عن مسؤوليته، واستقال الفكر من مهامه، وهاجرت الحكمة من ألسنة الناس، بل من صدور النخب.
ذلك أن من أعوص ما ورثناه عن العقود الماضية، إرث القمع والعسف وكسر الإرادات، وأيضًا ذلك الدمار الهادئ الذي أصاب طريقة تفكيرنا، والذي لا تُرى شظاياه بالعين، بل تُلمَح في لغة الناس، وفي نظرتهم لأنفسهم، وفي الكيفية التي يصفون بها وطنهم وعدوهم، ويحتكمون بها إلى مفاهيم لا يعرفون من أين وردت، ولا كيف استقرّت في وعيهم.
وهنا يبرز وجهٌ آخر من وجوه الكارثة: الصراع الفكري الذي يسهم بفاعلية في تعميق التخلف وتعطيل أدوات النهوض. وقد تطورت أساليبه كثيرًا، وإن بقيت مرتكزاته القديمة التي وصفها مفكرون كبار كمالك بن نبي حاضرة ومؤثرة. ما يبعث على القلق هو أن أكثر هذه الأساليب فاعلية يتمثل في إغراق النخبة العلمية والثقافية في خيانة القضايا الكبرى التي لطالما أجمعت عليها الشعوب الباحثة عن الكرامة والحرية. كثير من المفكرين والكتّاب والمثقفين بدأوا مسيرتهم وهم يحملون مشروعًا تحرريًا ضد الاحتلال والاستبداد والفساد، ثم انتهوا، بمرور الوقت أو تحت الضغوط أو الإغراءات، في مواقع تبرّر هذا الثلاثي الخطير أو تسوّغه. ليست المشكلة في الأسماء، فهي كثيرة ومعروفة، بل في الظاهرة نفسها التي تشير إلى أننا لم ننجُ من قبضة هذا الصراع الخفي. إن أخطر ما يمكن أن يصيب مجتمعًا هو أن تُختطف نخبته الفكرية، فيغدو المثقف، بدلًا من أن يكون ضميرًا ناقدًا، أداة تزويق وتسويغ. يتم ذلك أحيانًا من خلال استغلال نقاط الضعف الشخصية، أو عبر الإحاطة بعوامل ترغيب وترهيب، أو بخلق بيئات إعلامية وفكرية تدفع النخب لتغيير بوصلتها دون أن تشعر بذلك تمامًا. هذه الظاهرة لا تستدعي الشماتة ولا التشفي، بل تستدعي الحزن، لأنها تمثل نزيفًا ناعمًا في أخطر موقع: موقع القيادة الثقافية والفكرية. والمحصلة أن المجتمع يُترك بلا بوصلة واضحة، يتخبط بين شعارات ماضوية وشبكات مصالح معاصرة، بينما يغيب عنه من يُفترض أن يقود النقاش العام نحو وعي أعلى ومسؤولية أشمل. لهذا لا بد من الانتقال من ردّات الفعل إلى التفكير الجاد، ومن المعالجة الانفعالية إلى التفكير الاستباقي الوقائي، في سبيل بناء بيئة معرفية تُحصّن النخب من الانزلاق، وتُعيد الاعتبار للفكر النقدي المستقل، لا التابع ولا المأجور.
نشأ جيل كامل لا يميز بين الرأي والمعلومة، ولا بين الإشاعة والتحليل، ولا بين التعبير والانفعال، وهو ما نراه جليًا في ساحات الإعلام، ومنصات النقاش، وأحيانًا في مراكز اتخاذ القرار نفسها.
ولعل أبرز مظاهر الأزمة الفكرية في سوريا يمكن تلخيصها في ما يلي:
1. تفكك المفاهيم المركزية: فقد أصبحت كلمات مثل الحرية، الدولة، العدالة، المواطنة، وغيرها، محل تأويلات متضاربة، كلٌ يجرّها إلى مشروعه أو ألمه أو جهته. لا يوجد إطار مفهومي جامع، ولا مرجع معرفي يُحتَكم إليه، فباتت المصطلحات أدوات صراع بدل أن تكون أدوات فهم.
2. هشاشة المنهجية: إذ غالبًا ما تسود طريقة التفكير القائمة على التعميم، والخطاب العاطفي، والاحتكام إلى الموروث الشخصي أو التجربة الخاصة، بدل التحليل المركّب القائم على تعدد الزوايا، والربط بين السياق والتفاصيل، والتمييز بين الظرفي والبنيوي.
3. الازدواجية المعرفية: فالفرد السوري – في الغالب – يعيش بين ثقافتين متصارعتين داخله: ثقافة شعاراتية مشحونة بالمقولات الكبرى التي فقدت فعاليتها، وثقافة يومية براغماتية خالية من المعنى، يمارسها ليعيش ويتأقلم. وهذه الفجوة تُنتج عقلًا مضطربًا، لا يستطيع أن يربط بين ما يؤمن به وما يفعله، ولا بين ما يريد تغييره وما يعرضه من بدائل.
آن للعقل السوري أن يُستَفتى بعد طول إهمال، وأن يُسأل: كيف نُفكّك هذا التداخل الفادح بين الموروث والخرافة، بين الهوية والتعصب، بين الكرامة والتبعية؟
وإذا كان كثير من الساسة يتحدثون عن الاقتصاد، وعن السلاح، وعن الأمن، فإن أصل البلاء فينا ليس فيما نملكه أو نفقده، بل في الصورة التي نرسمها لما نملكه، وفي المعنى الذي نسبغه على ما فقدناه. من هنا تبدأ حكاية الإصلاح، ومن هنا وجب أن يُعاد ترتيب سلّم الأولويات.
الرئيس أحمد الشرع، في حواره مع صحيفة أمريكية، نطق بلسان السلطة، وبكلمات المنتصر، وتحدّث بما يشبه اعتراف الذاكرة المرهقة، حين قال: لا نبدأ من الصفر، بل من الأعماق. تلك العبارة على بساطتها، تختصر مشروعًا طويل النفس، لا يبني على الإنكار، ولا ينجو بالتجاهل، بل يفتّش في عمق الجرح عن معنى يضبط الحركة، ويصوّب المسار.
كانت إشاراته الرمزية – من إطلاق سراح الموقوفين، إلى مخاطبة المجتمع الدولي بلغة متجاوزة للشعارات – تدابير سياسية، بل محاولة لردّ الاعتبار لصوت العقل، الذي كثيرًا ما أسكته الرصاص، وتوارى خلف الأيديولوجيات المتصادمة. فتح الشرع نافذة صغيرة، لا إلى الماضي ولا إلى الحلم، بل إلى لحظة واقعية، يُمكن فيها للوعي أن يعود ليمسك بخيوط التفسير، والتدبير، والتصحيح.
إلا أن العقل، حتى يُستعاد، يحتاج إلى تحرير لغته أولًا. رحم الله نزار قباني إذ قال، وهو يشهد ما حلّ بالكلمات: أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمة، والكتب القديمة... أنعي لكم كل فكر قاد إلى هزيمة. فاللغة ليست صوتًا فحسب، بل طريقة في النظر، ومرآة خفية لمخزون النفس، تنبئنا عمّا نخشى، وعمّا نحب، وتكشف مقدار اتساعنا أو ضيقنا، ضعفنا أو قوتنا.
والحق أن ما حكمنا، وما أسهم في انكسارنا، لم يكن السيف وحده، بل تلك اللغة التي تبارك السيف، وتبكي عليه حين ينكسر. لغةٌ قديمة، تأبى أن تموت، لأنها محميةٌ برجالٍ يبدون أعداء لها، لكنهم لا يعيشون إلا بها. يتعاقبون على ترديدها في الخطب، والمناهج، والدواوين، وحتى في زوايا الثورة.
نعم، إن اللغة التي ربتنا على الخوف، وأقنعتنا أن الأمن هو الصمت، وأن الدولة هي اليد الغليظة، وأن المواطن هو الحاشية، لم تفارقنا بعد الثورة. بل عادت على ألسنةٍ جديدة، تمجّد زعيمًا آخر، وتعيد تبرير القمع باسم مقاومة القمع. عادت، حين أصبح الممول هو السيد، والانتماء هو التبعية، والمصلحة هي المشروع. عادت، حين تحوّلت شعاراتنا إلى طبول، لا تقول الحقيقة، بل تضرب لإخفائها.
ليس هذا حزنًا لغويًا، بل نداءٌ للمعنى. فاللغة، كما قال الأقدمون، هي صورة الأمة. وإذا اختلط في هذه الصورة دم الشهيد بعبارات الطغيان، فإننا لم نتحرّر بعد. ولن نبني سوريا جديدة، بل سننقل أطلال اللغة المهزومة إلى خرائط جديدة، ونخطّ بها انكسارًا آخر.
لعل ما يضيء طريق الخروج، ليس خطاب رئيس يحاول أن يُصغي، ولا في توبة شاعر من لغة الهزيمة، بل في استعادة جوهر السؤال: ما اللغة التي نختار أن نحيا بها؟ اللغة التي تحترم الإنسان وتُعرّف به، أم التي تختزله في وظيفته أو طائفته؟ اللغة التي تقول الحقيقة، أم التي ترقّعها؟ اللغة التي تسأل، أم تلك التي تُقسم وتلعن؟ اللغة التي تفسح، أم تلك التي تضيق وتُقصي؟
إن في إدراج اللغة الكردية في الإعلام الرسمي مثلًا، لا عبثًا كما يظن بعضهم، بل تصحيحًا لمعنى الوطن. فمن يهاب جملة كردية في نشرة أخبار، هو ذاته من يهاب الحقيقة. ومن يتوجّس من أن يُقال "مساء الخير" بلغتين، لم يعرف بعد أن الوطن الحقيقي هو ما يتسع لِمَن يختلف، لا لمن يُشبه.
سوريا التي نطلبها، لا تُبنى بلغة مهيمنة، ولا بصوت واحد، بل تتأسس حين يصير التعدد أصالة لا استثناء، والشراكة وجدانًا لا منحة، والكرامة حقًا لا تفضلًا. وما لم نُبدّل هذه اللغة العتيقة، سنظل نبني أحلامنا في ظلِّ جملٍ مهزومة، ونعيد إنتاج أعدائنا بكلماتنا نحن.
ومن لا يزال يُطوّف في فلك تلك اللغة، ويهتف لمن خدعه، أو يبرر لمن قهره، فهو – وإن بدّل وجهه أو رفع